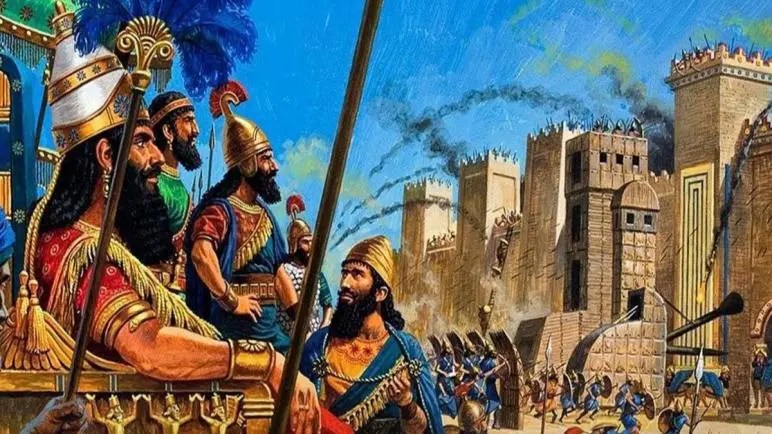بعد دراسة متأنية للواقع الجغرافي والتاريخي والسياسي لسوريا، يتضح أن مفهوم “الوطن” قد يكون مجرد وهم سياسي يُستخدم لتعزيز السلطة وبناء النفوذ على حساب الأقليات. قبل صعود حزب البعث إلى السلطة في ستينيات القرن العشرين، كانت سوريا عبارة عن كنتونات طائفية وعرقية منفصلة، تضم دولة علوية في الساحل، ودولة درزية في جبل العرب، وكنتون سني في دمشق، إلى جانب وجود محدود لليهود وأعداد قليلة من المسيحيين، فضلاً عن مكونات أخرى مثل الأكراد، الشراكس، والتركمان إلخ.. لم يكن التضخم السكاني أو التوسع العمراني قد بلغ ذروته آنذاك.
مع وصول حزب البعث العلماني إلى السلطة عام 1963، تم توحيد هذه الكنتونات تحت شعار «الوحدة والحرية والاشتراكية». أدخل البعث مفهوم العلمانية المتمثل في “الدين لله والوطن للجميع”، وسيطر على الأراضي السورية بعد فترة من الصراعات السياسية والإنقلابات العسكرية. لم يعتمد البعث على صدامات طائفية أو عنصرية مع المدنيين، بل ركز على نهج عسكري منظم، مما ساهم في نجاحه شعبياً وتمكنه من تسلم السلطة تحت راية المواطنة والجمهورية.
الواقع السياسي اليوم يتجسد في غياب التوافق الوطني في عام 2025، يبدو المشهد السوري مغايراً تماماً لما كان عليه تاريخياً وسياسياً، ولا يوجد توافق وطني حول هرم السلطة في سوريا، بل هناك قوقعة سياسية تحكم تتربع على رأس الهرم بالحديد والنار، تعكس لوناً سياسياً واحداً، إجتماع مؤتمر “كونفرانس شرق الفرات”، الذي جمع مكونات سوريا المتضررة سياسياً من الأكراد، الدروز، العلويين، وسكان الجزيرة المحليين، شكل إحراجاً كبراً للحكومة السورية، لكنها لم تتجاوب مع دعوات الحوار الوطني، وإستمرت في سياسة الإقصاء المباشر وغير المباشر، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه المماطلة مقصودة لتصفية ملفات معينة مثل الملف الكردي، بضغط من تركيا.
تتركز المعضلة السياسية في شرق الفرات، حيث يشكل الإقليم الكردي مصدر قلق كبير لتركيا وإيران عموماً وتركيا خصوصاً إن تتخوف أنقرة من قيام «دولة قومية كردية» قد تمتد إلى داخلها، مما يهدد أمنها القومي ويؤثر على ولاء الأكراد داخل تركيا. تعتمد تركيا إستراتيجية “الجَمّ والقضم” التاريخية، كما فعلت عند ضم لواء إسكندرون عام 1939، حيث أدرجته إدارياً ضمن جغرافيتها وذوبته تدريجياً في الجغرافيا والتركية، اليوم تسعى أنقرة لإعادة صياغة هذا المشروع عبر إقامة منطقة عازلة حدودية تشمل الولاية 82 حلب وشرق وغرب الفرات، تحت مسمى «الدولة التركمانية الجديدة»، وهو مصطلح يُترجم إلى “دولة رجال الترك” باللغة الإنجليزية، بهدف ضم هذه المناطق تدريجياً إلى الجغرافيا التركية أو تطويعها أيديولوجياً.
في المقابل، لا يشكل الملف العلوي ورقة ضغط سياسي بارزة، إذ يعاني العلويون من التهميش السياسي والإقصاء الإجتماعي في الوقت الحالي وغياب فصائل شعبية أو أحزاب مناهضة قادرة على ملئ الفراغ السياسي. أما الملف الدرزي، فقد خرج شبه كلياً عن سيطرة الحكومة في دمشق، خاصة بعد الإحتجاجات في السويداء عام 2025، التي تزامنت مع تدخل إسرائيلي دبلوماسي واضح، مدعوم من اللوبي الدرزي في الكنيست الإسرائيلي.
فمنذ عام 2018، عززت إسرائيل وجودها في الجنوب السوري، خاصة في منطقة القنيطرة وهضبة الجولان المحتلة. استغلت إسرائيل حالة الضعف السياسي والعسكري في سوريا لتوسيع نفوذها عبر دعم فصائل محلية وتقديم مساعدات إنسانية ولوجستية لتعزيز ولاء السكان المحليين، خاصة الدروز. بحلول عام 2025، أنشأت إسرائيل منطقة عازلة فعلية في الجنوب السوري، ممتدة من حدود الجولان إلى مناطق قريبة من درعا، بهدف تأمين حدودها الشمالية ومنع أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة أو نفوذ إيراني. هذه المنطقة، التي تُدار تحت إشراف ومساندة إستخباراتية وعسكرية إسرائيلية، تهدف إلى خلق حزام أمني يعزل دمشق عن الحدود الجنوبية، مما يعزز التقسيم الفعلي للأراضي السورية.
تمتلك تركيا وإسرائيل طموحات توسعية متشابهة، لكنهما تتبعان منهجين مختلفين. تعتمد تركيا على «الإيديولوجية الدينية» الإسلامية لإختراق المجتمعات العربية، مستغلة الصبغة الإسلامية الأكثرية لتذويب الحدود الجغرافية والعرقية شيئ فشيئ. أما إسرائيل، فتستخدم الدبلوماسية والدعم العسكري والإستخباراتي والتطور التيكنلوجي والعسكري لفرض سيطرتها على مناطق إستراتيجية، كما في الجنوب السوري. وإن كلا الدولتين تسعيان لإعادة رسم الخريطة السورية لصالحهما، مستغلتين الإنقسامات الداخلية وغياب سلطة مركزية قوية.
سوريا اليوم تتأرجح بين طموحات إقليمية متصادمة، حيث تسعى تركيا لضم أجزاء من الشمال السوري عبر منطقة عازلة، بينما تعزز إسرائيل سيطرتها على الجنوب من خلال منطقة عازلة أخرى أو السيطرة الإيديلوجية على سوريت، في ظل غياب حوار وطني حقيقي وإستمرار الإقصاء السياسي للمكونات الأساسية، وتبقى سوريا ساحة للصراعات الإقليمية مما يهدد وحدتها الجغرافية وهويتها الوطنية الجامعة